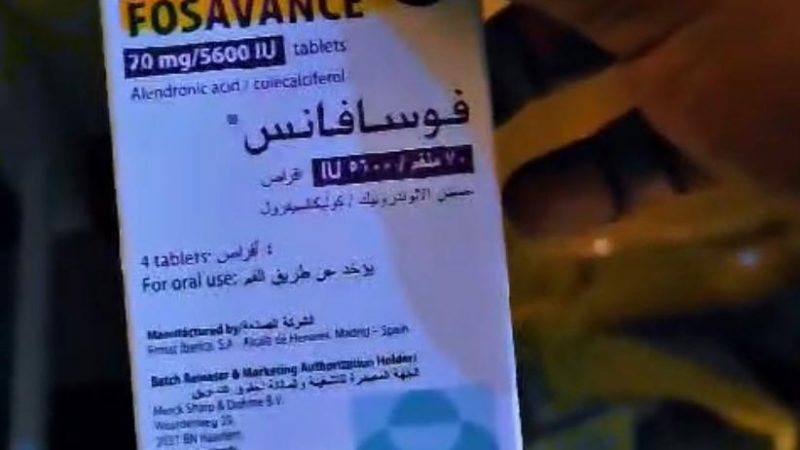العنف القبلي في السودان .. النيل الأزرق نموذجا

عصام شعبان
تضيف أحداث العنف الجهوي والقبلي تحديات تحيط بالسودان، منها أزمات على الصعيدين، السياسي والاقتصادي، كما تأتي ضمن سياقاتٍ تاريخية، منها إشكالية بناء الدولة، ونظم الإدارة والحكم المحلي، وإخفاق نظم حكم عسكرية، وأخرى مدنية قصيرة العمر، في إيجاد تعايشٍ سلميٍّ، في بلدٍ مترامي الأطراف، متعدّد الثقافات والأعراق، غير مشكلات التنمية العميقة.
ومع اشتداد الصراع على السلطة، بعد انقلاب أكتوبر (2021)، تظلّ ملفات السلام عصيةَ على التقدّم، ومطالب العدالة وإزالة التهميش غير ممكنة، ما يحفّز دوائر العنف مجدّدا، خصوصا مع مؤشرات اقتصادية واجتماعية دالّة، وبنية سياسية هشّة تنتج صراعاتٍ متكرّرة، وتزيد معدلات النزوح والضحايا من المصابين والقتلى. وتفيد بيانات أممية نشرت أول أغسطس/ آب 2022 بأن “ربع السكان يواجهون انعداما حادّا في الأمن الغذائي” نتاج الاقتصاد الهشّ وانخفاض المساحات المزروعة، هذا يعني مستقبلا تولّد صراعات جديدة، وعنف يرتبط بندرة الموارد وحالة التنافس عليها، وضمنها صراعات ذات طابعي موسمي، تتجدّد وتبرز خلال فصول الصيف، وترتبط بعوامل مناخية وحغرافية متّصلة بموارد المياه والمراعي وعوامل الجفاف وما تتركه من هجرات داخلية أو نزوح وصراعات على الموارد ترتبط بتغيير الخريطة الديمغرافية.
وأخيرا، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حصيلة الصراعات في الولايات أدت إلى مقتل 322 شخصا وإصابة 329 آخرين، ونزوح أكثر من 163 ألفا من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز، وبلغ النازحين نحو 35 ألفا في مايو/ يونيو، بينما يوجد 3.1 ملايين نازح داخليا في السودان، خصوصا في إقليم دارفور، والذي ما يشهد هدوءا نسبيا إلا وتجدّد أحداث العنف في ولاياته، كان جديدها أخيرا أحداث عنف أول أغسطس/ آب، بينما اندلعت أحداث عنف النيل الأزرق وكسلا خلال يوليو/ تموز، واستمرّت أصداؤها حيث لم تمنع المصالحات من تجدّدها مرة أخرى، بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وأدّت إلى مقتل 20 مواطنا وإصابة العشرات.
حصيلة الصراعات في الولايات أدت إلى مقتل 322 شخصا وإصابة 329 آخرين، ونزوح أكثر من 163 ألفا من يناير حتى يوليو
وفي المطالعة قراءة في أحداث النيل الأزرق كحالة دالّة على وقائع العنف ومرتكزاته، وتفاعل أسبابه مع مشهد الصراع السياسي بين قوى الثورة وتحالفات السلطة، وأيضا إشكالية التنازع على الموارد، في ظل نظام الإدارة الأهلية، وما تمثله من نظامٍ للضبط والحكم المحلي، يتّخذ موقعا مهما في البناء السياسي والاجتماعي في السودان، ويحدّد علاقات النفوذ والسيادة على الأرض في الأقاليم وعلاقتها بالصراع الجهوي والقبلي.
كيف تبدأ أحداث العنف
يبدأ مشهد العنف بحدثٍ طارئ، مقتل أحد أفراد القبيلة خلال إغارة أو تعدٍّ على مساحات أراض زراعية أو رعوية، كما جرى بين الهوسا وألبرتا في النيل الأزرق، أو ولايات دارفور، والتي ما زالت مسرحا للصراع، تتّسع الأحداث، مخاطبة دوافع العنف الظاهرة والكامنة، وحين تعجز أجهزة السلطة، والضبط الرسمي والاجتماعي، في حلّ المنازعات تبقى وإن سكنت، وتعود مرة أخرى ارتباطا بجذورها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى عامل الثأر، وهو ما يمكن رؤيته في صراعاتٍ قبليةٍ في دارفور، أو ما يستجد من صراعات مشابهة.
أسباب العنف القبلي
يرتبط العنف هنا بجملة من الأسباب، أولا أزمة قديمة ترتبط ببناء الدولة وتخلّف نظم الإدارة، وثانيا أزمة مستجدّة ترتبط بعنف ما بعد الثورات والمراحل الانتقالية، والتي تتضمّن مشكلات تتعلق بإعادة توزيع الأدوار وفراغ في القيادة أحيانا، إضافة إلى التنافس على السلطة على مستوى قومي، والسعي إلى تحقيق النفوذ مع تخلخل أجهزة الدولة القديمة وشبكاتها الحاكمة وسقوط نخب قديمة، وسعى أخرى لشغل أماكنها من دون انتقال سلسل، ومع استمرار حالة العجز عن بناء أجهزة الدولة وإصلاحها بما فيها أجهزة الأمن، تفقد الدولة جزءا من دورها في التدخل السريع. وثالثا، يشكل غياب الاستقرار السياسي، وعدم كفاءة النسق السياسي في الضبط وتحقيق الرضا، غير قصورا عاما في أداء الدولة، ما يسمح بتمدّد العنف. ورابعا، يبقى الواقع السوداني، ورغم الثورة، رهين نسقٍ سياسي قديم لم يتغير، بما فيه من صراعاتٍ بين السلطة وحركات مسلحة، وصراع بين تلك الحركات، ما يُنتج مرتكزا للعنف، يأخذ مساحة التمظهر أحيانا في تحرّكات جهوية وقبلية.
مرتكزات العنف:
أزمة مكوّنات المجتمع والدولة
تلعب الأزمتان، السياسة والاقتصادية، بجانب مرتكزات تاريخية، لها صفة العمومية، دورا في العنف. وهناك أسباب ترتبط بحالة الأقاليم ومناطق الأطراف، وما تعانيه من مظالم وتهميش وتمييز، ما زالت مستمرّة، وضمن نتائجها نقص التنمية، وما تُنتجه من مصاعب معيشية، معدّلات بطالة مرتفعة، وتفاوت اجتماعي وتمييز يرتبط أحيانا بالقبيلة والجهوية، ما ينتج أشكالا من التعصب وسيادة خطاب الكراهية. وكانت كل هذه الإشكالات، وما زالت، دوافع لإنتاج العنف الذي يتمظهر في شكل قبلي أحيانا، لكن مضمونه اجتماعي غالبا، وإن اتخذ بعدا ثقافيا أو وظيفة سياسية.
وتعدّ السمات الاقتصادية والاجتماعية للإقليم ضمن دوافع إنتاج التمرّد والعنف والاحتجاجي السياسي، وهي الظواهر الثلاث التي شهدها الإقليم. وبجانب كونه مسرحا للحرب الأهلية، كان مركزا للاحتجاج السياسي، وبرز في ثورة ديسمبر (2018). وفي الوقت الذي لا ينفصل العنف الذي يأخذ شكلا قبليا، عن أزمة مسار الانتقال الديمقراطي بعد ثورة ديسمبر، وما أن تنتهي وقائع عنف إلا وتجدّد أخرى، رغم اتفاقات التهدئة والمصالحة، والتي لا تعالج أسبابا عمومية للعنف أو الصراع على الموارد.
وتبرز في السياق أزمتان، الأولى أزمة التنمية واستمرار سياسة التهميش والتمييز، كما عجزت الدولة عن إدارة التنوع الثقافي والديني والعرقي. وكانت النتائج حروبا في الشرق والغرب والجنوب، شهدتها مناطق دارفور وكردفان وجبال النوبا والنيل الأزرق، فضلا عن حرب الجنوب، والتي أسفرت عن انقسام السودان في 2011. وحاليا وبعد إخفاق الثورة، وفي ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تتوسّع، وعجز الدولة القيام بمهامها، وتعثّر في مرحلة الانتقال الديمقراطي، فإن الخطر حال واحتمالات تفاقم الأزمة قائمة بقوة، وتفتح سيناريو الفوضى والحرب الأهلية، خصوصا في ظل نقص معدلات التنمية، وارتفاع الضائقة المعيشية، والصراع والتنافس على السلطة.
وهناك أزمة هياكل الدولة، فوجود صراعات بين مكونات المجتمع تقابلها أزمة في مكونات الدولة، وكلاهما يمثّلان تهديدا للسلم الاجتماعي. ولا يمكن أن يُنتج استقرارا في ظل هذه الحالة، وبين بنية الدولة هناك أزمة أجهزة الأمن والقوات النظامية وصراعاتها، وغياب أدوار فاعلة لها ومقبولة في الصراعات القبلية والجهوية. ويتضح ذلك في حالة العنف التي اندلعت في النيل الأزرق، وحالات مماثلة. ويرجع ذلك في جانب إلى عدم تأهيل أجهزة الأمن، غير خللٍ يحتاج إصلاحا مؤسّسيا، بالإضافة إلى تأثر هياكل إدارتها بأطراف الصراع السياسي والقبلي أحيانا، يظهر فى دارفور التى عانت تاريخا طويلا من جرائم قوات الدعم السريع، وربما فى النيل الأزرق، تمت الاشارة وتبادل اتهامات حول تهريب السلاح، غير وجود تاريخ للحرب الأهلية في النيل الازرق، كما دارفور، وكانت السلطة طرفا فى الصراع، وما زالت مكوناتها قائمة.
العنف مركّب، ومتصل بصراع اجتماعي وسياسي
وسبق وأن وجّهت قوى ثورية اتهاماتٍ بتقاعس الأجهزة الأمنية وتأخرها في التدخّل، غير ما يشير إليه المشهد من ارتباك تلك الأجهزة نتاج تعدّد الصراعات والولاءات، كما يلاحظ أيضا، وكما بلدان عدة، تتراخى الأجهزة الأمنية في أداء عملها، وكأنها تعاقب من ثار ضد السلطة، وكانوا في مواجهة خلف المتاريس خلال الثورة.
وإجمالا يبقى الصراع على الموارد والنفوذ، بما فيها الأراضي والثروات المعدنية، إطارا للعنف في شرق السودان وغربه. وهذا العنف مركّب، ومتصل بصراع اجتماعي وسياسي، وبحكم أن القبيلة مكوّن اجتماعي وجزء من نسق سياسي، فإنه يتمظهر قبليا في بعض الأحيان، ويربط بين الصراع على المستويين المحلى والقومي. وبلا شك توظف فيه القبيلة والانتماءات الاولية التي تنشط مع غياب الهوية الوطنية الجامعة، ووجود مظاهر للتمييز الاجتماعي والثقافي، ومع حدوث تغيراتٍ عنيفةٍ في البناء السياسي، كما الانقلابات والانتفاضات والانقلابات.
الصراع على الموارد والنفوذ في ظل بناء سياسي قبلي
قبل شهرين من أحداث النيل الأزرق في يوليو/ تموز الماضى، والتي قضى فيها ما يزيد عن مائة قتيل (حسب وزارة الصحة) ومئات الإصابات وآلاف النازحين، شهدت الولاية حشدا قبليا متبادلا بين قبيلة الهوسا وعدة قبائل (منها ألبرتا). كان المشهد مؤهلا لاندلاع المواجهات، بعد سعى بعض قادة الهوسا إلى إقامة نظّارة لهم في الولاية، وما يترتب على ذلك من نفوذ ضمن بناء سياسي تقليدي يعتمد على (المشايخ، العمد، النظارة، الإدارة الأهلية)، وخلاله يتم تقنن مسألة السيادة على أراضي الزراعة والرعي، وهو ما تراه القبائل التي تصنّف قبائل أصلية صاحبة الأرض، تعدّيا وتجاوزا لقواعد تنظيم العلاقات والملكية، والتي لا يحقّ لقبيلة الهوسا حيازتها بوصفها قبيلة وافدة (من غرب أفريقيا).
الشكل التقليدي المنظم لعلاقات ملكية الأرض غالبا ما يكون عاملا أساسيا في الصراعات القبلية
الشكل التقليدي المنظم لعلاقات ملكية الأرض غالبا ما يكون عاملا أساسيا في الصراعات القبلية، بالإضافة إلى ذلك في حالة الهوسا تحديدا، تتوفر دوافع عدة، لتسعى القبيلة إلى تغيير أوضاعها، عبر تأسيس نظارة، تضمن لهم مكانة اجتماعية وسياسية. وهذا ما يفسّر اتساع نطاق الاحتجاجات وتخطيها ولاية النيل الأزرق إلى كسلا وغيرها من الأقاليم، والتظاهر في الخرطوم أيضا ضد ما لحق بهم من اعتداءات.
ويتوفر لدي الهوسا وزن ديمغرافي ضخم (ما يقارب ثلاثة ملايين في السودان)، غير شعورها بالغبن والتمييز قديم، وربما تاريخيا، سواء فيما يتعلق بأنهم سوادنيون، أو بحملات ترحيلهم من الخرطوم قديما. والشعور بالتمييز هنا مرتكز للعنف شهدته مناطق أخرى، سواء على أسس جهوية أو عبر تقسيم القبائل إلى وافدة وأخرى أصيلة، أو تصنيفها إلى قبائل عربية وأخرى غير عربية.
وبهذا، يمكن أن تندفع القبائل الوافدة في المسار نفسه، كما المساليت، والتي دارت بينها وبين قبائل أخرى صراعات مشابهة كان مركزها التمييز وموضوعها التنافس على الأرض والمراعي. وفي ولاية النيل الأزرق، سعت الهوسا إلى إثبات هويتها عبر تأسيس نظّارة لأهلها يؤكد وجودها الاجتماعي، وهو ما يؤشّر إلى أن هذا السيناريو مطروح بقوة في بعض أقاليم السودان، سواء على مستوى الحراك بشكل جهوي أو قبلي، طالما ظلت هوية القبيلة والجهة هي الغالبة في التنظيم، وتمثيل أفرادها بوصفها حركة مطلبية، وهو ما يكشف أزمة الهوية منذ ميلاد دولة الاستقلال، كما يكشف، ورغم فاعلية سياسية قديمة لشعب السودان، عن مأزق التنظيم عبر القبيلة.
صراع قبلي قابل للتوظيف
تركت حالة التنافس بين الحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، والجبهة المقابلة بقيادة عبد العزيز الحلو، آثارها في تفسير الأحداث، كما دارت مناوشاتٌ كلامية بين جبهة مالك عقار والحزب الشيوعي، واعتبر الحزب (وآخرين) في بيانات رسمية اتفاقية السلام التي وقعتها جبهة مالك عقار شكلا من محاصصة سياسية، لم تعالج جذور التهميش وأسباب الحرب، وربما تكون سببا في إشعالها مرة أخرى.
ترك الصراع بين جناحي الحركة الشعبية آثاره على الإقليم، بما فيها من تداخل بين الانتماءين السياسي والقبلي، غير ما تراه قوى الثورة من أن تحالف الجيش الحاكم اليوم أكثر طرف مستفيد من الأحداث، لأنه يوفر أرضيةً لتثبيت حكمه عبر بوابة حفظ النظام والأمن، ووقف الاضطرابات التي تهدّد السودان، بينما أصوات من السلطة وأنصارها يردّدون خطاب المؤامرة، ويشيعون أن هناك قوى مدعومة من أطراف خارجية تريد تقسيم السودان ونشر الفوضى، وهو ذاته الخطاب الذي تصاعد مع الثورات العربية كأداة للثورة المضادّة في الدفاع عن نفسها، والتحصن بالوطنية في مواجهة المحتجين الذين يتم اقتيادهم عبر ممثلين لأطراف خارجية، حسب تصور أصحاب نظرية المؤامرة. في المقابل، تتردّد اتهامات بأن جبهة مالك عقار حاولت اكتساب أرضية سياسية في الإقليم الذي تحكمه من أجل إحكام السيطرة عليها، مستعينة بقبائل الهوسا، ومستفيدة من توظيف ما تعرّضت له من تمييز ومظالم لتقف بجوار جبهة عقار مستقبلا، والتي تفقد سندا اجتماعيا قبليا يدعم نفوذها في ولاية النيل الأزرق وبعض ولايات السودان، خصوصا بعد انقسام الحركة واصطفاف جبهة مالك عقار مع تحالف الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، بينما الجبهة الأخرى تناوئ هذا التحالف، وترفض الانخراط في اتفاقيات سلام جوبا.
ترك الصراع بين جناحي الحركة الشعبية آثاره على الإقليم، بما فيها من تداخل بين الانتماءين السياسي والقبلي
وعلى الرغم من هذا المشهد المليء بالاتهامات، إلا أن مرتكزات العنف في النيل الأزرق والحالات الشبيه لها متشابكة، ولا يمكن تفسيرها عبر سبب واحد، حتى وإن حملت الاتهامات أسانيد، ولعبت دورا في اشتعال العنف القبلي والتحرّكات الجهوية الغاضبة، والتي تقف خلفها عوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية متشابكة، منها ما يخصّ عجز هياكل الدولة ومؤسّساتها، وما يرتبط بالبناء الاجتماعي غير ما تُحدثه الثورة من تفاعلات جديدة.
وتنتج ما بعد الثورة ما يعرف بعنف المراحل الانتقالية التي تبرز فيها الصراعات الاجتماعية والسياسية، وما تولّده من نزعات نحو الرجوع إلى الانتماءات الأولية، إذ لم تجد قطاعات من الجماهير من يمثلها، كما يشير ابيستاين إلى أن “العرقية تظهر غالبا في ظروف الهياج الاجتماعي والتحول”. وفي كل الأحوال، لا يمكن اعتبار أن عاملا وحيدا يقف خلف العنف، نظرا إلى تعقد الظاهرة، كما لا تُعتبر الأسباب المباشرة، كما النزاع على حيازة الأراضي والسيادة عليها، سببا كافيا للتفسير، حتى وإن تكرّر العامل الاقتصادي، واعتبر عاملا رئيسيا. وزاد وزنه النسبي بين مجمل أسباب العنف، ولكن يلحظ أن نظام الإدارة الأهلية، وما يرتبط به من تاريخ مؤسّس للسلطة عبر القبيلة، وما يرتبط به من عمليات توزيع النفوذ والثروات عاملا مؤثرا.
نظام الإدارة الأهلية من التوظيف الاستعماري إلى الثورة المضادّة
اعتبر المؤرّخ البريطاني، روبرت كولينز، أن فهم السودان يعتمد على معرفة العوامل المؤثرة في الأحداث، بما فيها الأكثر صمودا، ومنها الحجم والتنوع الكبيران، في بلد مترامي الأطراف يحتوي تنوّعا أثنيا وعرقيا ومناخيا ولغويا، غير مكوّن ثالث، وهو العنصرية الثقافية المبنية على أساس تاريخي وثقافي، أكثر من التقسيم على أساس اللون، وتعدّ العنصرية الثقافية محدّدا لمكانة الجماعة على حساب الجماعات الأخرى، وهو ما أنتج عنصريةً سياسيةً، تحتكر من خلالها المناصب، وربما يفسّر هذا المدخل مشاهد العنف التي تتّخذ بعدا قبليا أحيانا، وتطرح سؤالا من هو السوداني اليوم، وإشكالية بقاء معايير الملكية وحيازة السلطة في بعض أقاليم السودان على أساس تقسيم للقبائل بين محلية وأخرى وافدة غريبة، حتي وإن كانت تسكن الأرض مئات السنين، غير تقسيماتٍ ما بين عربي وأفريقي، وما تسبّبه من صراعاتٍ وتفسّخ اجتماعي. وغيرها من تقسيماتٍ وظفها الاستعمار والسلطات المتعاقبة لتحصين نفسها، واستدامة حكمها من جانب، وتعطيل التحلق حول مشروع وطني تنموي، أساسُه المساواة والمواطنة الكاملة، أو ما كانت تطمح إليه ثورة ديسمبر (2018) من بناء سودان جديد لكل مواطنيه. لذا تقف النزاعات والصراعات القبلية والجهوية في مواجهة تقدّم الثورة وتحقيق برنامجها وتشلّ الوحدة التي أظهرتها الثورة ضد السلطة، لصالح تقسيمات جهوية وقبيلة يذوب فيها مشروع التغيير الشامل إلى مطالب محدودة، وتعتبر الإدارة الأهلية بما تتركه من صراعات، واستبعاد وحرمان أدوات للثورة المضادّة يمكن توظيفها، إحدى المخاطر ومنطلق للعنف القبلي.
الإدارة الأهلية دعم السلطة التقليدية في مواجهة الحركة الوطنية
منذ بدايات القرن العشرين، بحث السودانيون عن هويتهم. طمح جيل المتعلمين إلى تولّي مواقع الحكم والإدارة، لكن الاحتلال البريطاني كان يخشى هذا التوجّه الذي يعنى حتمية الصدام معه. يورد روبرت كولينز في كتابه “تاريخ السودان الحديث” أن لجنة ملنر الشهيرة رفعت، ضمن توصياتها بعد ثورة 1919 المصرية، “عدم تشجيع الاعتراف والتوسّع في الطبقة الجديدة من المتعلمين، والتي من المفترض أن ترث مستقبلا المهام الإدارية، كما اقترح نظاما للحكم غير المباشر بحيث لا يتم تسليم وظائف الحكم إلى النخبة السودانية، وإنما تترك للسلطات التقليدية من شيوخ ونظار وعمد، وقد مرّت مرحلة الحكم غير المباشر بثلاث مراحل كوسيلة الدراية مفيدة، ثم كمذهب سياسي ثم ديني، مما وفر ميزة التكلفة المنخفضة للحكم والسيطرة البريطانية. وفي سبيل ذلك، دعمت بريطانيا السلطة القبلية التقليدية كإطار للضبط الاجتماعي المعتمد على علاقات القرابة والجهة، وأضيف إليها دورا سياسيا مباشرا، استمرّ فيما بعد، وعزّز بما أضيف إليها من علاقة مع السلطة من خلاله تعظيم مكتسباتها، لم يدشّن البريطانيون الإدارة الأهلية، فهي أقدم من دعمهم لها، ولكن الإنجليز عملوا على شرعنتها.
شرعنة نظام الإدارة الأهلية
طبق في بادئ الأمر نظام الإدارة الأهلية في قبيلة المساليت، العام 1922 حسبا ما جاء في تقرير سير لي ستاك، الحاكم العام للسُّودان، حيث حكمها سلطان من أهلها، ترك له أن يدير الشؤون الداخلية لمملكته الصغيرة تحت إشراف “مقيم بريطاني”. حسب ما نقله عبد الله حسين في كتابه “السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية” (ثلاثة أجزاء، 2016)، والذي يشير فيه إلى أن نظام القبائل كان متابعا قبل فتح محمد علي 1821، ولم يشأ الحكم المصري أن يتدخل، ترك لمشايخها أكثر ما كان لهم من السلطة على أن ينفذوا الأوامر التي تصدر إليهم، وأن يحصِّلوا الضرائب، وعلى أن لا يقوموا بأي عمل مضرّ بمصالح الحكومة، وأن تكون الإدارات الأهلية في دور التبعية للسلطة، وهو الدور الذي استمرّ فترات طويلة، إلى أن أصبح سمة غالبة عليها، وخصّصت ميزانية خاصة للإدارة الأهليَّة عام 1925 بدار المساليت، وهي القبيلة التي كانت سنوات طويلة طرفا فى نزاعات قبلية فى دارفور مع قبائل عربية، خصوصا مع حكم عمر البشير، وقد تجدّدت أعمال العنف بعد الثورة فى دارفور، وأخيرا فى منطقة الجنيينة في إبريل/ نيسان الماضى، وأسفرت عن مقتل مائتي مواطن منهم، ذلك نتاج هجوم شنته قوات الجنجويد، ونزوح آلافٍ من السكان. بدا العنف نتاج مقتل رجلين، ثم اندلعت اشتباكات بين أفراد من المساليت وقبائل عربية، قبل أن تتدخل قوات الجنجويد بشكل منظم. ولم تقم أجهزة الأمن بدور مؤسّسي، نظرا إلى التداخل ما بين أفراد من الشرطة لهم انتماءات قبلية، بالإضافة إلى صراع سياسى بين جماعات مسلحة فى الإقليم، انضمّ بعضها إلى اتفاقية سلام جوبا وبعضها رفضها، وانعكس هذا الانقسام على دوامة العنف.
لم تقم أجهزة الأمن بدور مؤسّسي، نظرا إلى التداخل ما بين أفراد من الشرطة لهم انتماءات قبلية
وتتشابه الوقائع في الجنينة مع إقليم النيل الأزرق، فيما يخص الصراع على الموارد والأرض، غير ما تحتويه أراضي الإقليم من الذهب، والذي ستعود عمليات التعدين بالفائدة على المسيطرين على الإقليم سياسيا، بينما في النيل الأزرق، هناك فرصة للتعدين واستخراج البترول، والذي جعل الصراع أيضا يحتدم بين مكوّنات الإقليم التي ستستفيد من تلك المشروعات، بحكم وجودها فى هياكل الإدارة الأهلية.
نموذج الولي والتابع: تقاطعات بين البناء السياسي والاجتماعي
غالبا ما يتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد دقلو (حميدتي)، بأنه مستمرّ في سياسة الحشد القبلي، وتعزيز نفوذ قوات الدعم السريع عبر الدعم من زعماء القبائل وكسب ولائهم مقابل ضمان سيطرتهم على الأراضي، وهي السياسة التي يتّبعها لتعزيز نفوذه أيضا، كما بدايات تأسيس “الجنجويد” حتى تحوّلها إلى مليشيات، ثم شرعتها داخل النظام السياسي للبشير. لقد كانت علاقات التبعية بين زعماء القبائل والسلطة قديمة ومترسّخة في السودان، عبر تحويلها من شكل اجتماعي للضبط وحل النزاعات إلى جزء من الإدارة والضبط السياسي. وفيما بعد وفي عهد البشير إلى ما يشبه الوحدات السياسية المقرّبة أو الشريكة في حزب المؤتمر الوطني.
القبيلة في مواجهة التحديث وبناء الدولة .. مؤسسة الإدارة الأهلية:
حسب المؤرّخ كولينز، تجاهلت عمليات تمكين زعماء القبائل والإدارات الأهلية تطلعات المتعلمين الذي تصوّروا أنهم الورثة للحكام البريطانيين، بل أن بعض هذه القرارات، كما مرسوم سلطات المشايخ الصادر عام 1927، منح سلطاتٍ للشيوخ في المجتمعات الزراعية المستقرّة، ما أحدث تحوّلا دراميا للإدارة في السودان من أقاليم محدّدة جغرافيا إلى حكام لجماعات عرقية منفصلة، بغض النظر عن الحدود الإدارية.
منذ 1928 ربط عديدون من مشايخ القبائل بالحكم البريطاني، وأصبحوا جزءا من نظام إداري يمارسون الحكم، وخصّصت الإدارة البريطانية لهم مكافآت أو مرتبات لرؤساء المحاكم ومشايخ القبائل مقابل الأعمال المنوطة بهم.
وفي 1943، أسس المجلس الاستشاري لشمال السودان، وضم 28 عضوا، 18 منهم ممثلون للمجالس الإقليمية تضمن المصالح المحلية، وهو يقارب ما حاولت أن تصدّره أو تستعيده تحالفات الجيش بقيادة البرهان، حين حرّضت رموزا قبلية للمطالبة بتمثيلها، بوصفها قوى اجتماعية، في المجلس السيادي قبل انقلاب أكتوبر. وبدا أن البرهان وحميدتي كليهما يدفعان في هذا الاتجاه لمواجهة تحالف قوى الحرية والتغيير (قبل أن ينقسم)، والذي كانت تمثله حكومة عبدالله حمدوك ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية، وفقا لاتفاق تقاسم السلطة بين المعارضة والجيش، أغسطس/ آب 2019، أي أن تحالف الجيش حاول استغلال قوة الإدارات الأهلية وقيادتها في المناطق المحلية، لكي تمارس السلطة وشرعتها، لتّتخذ دورها في تحالف الجيش. وهكذا تبادل الجيش والإدارات الأهلية الشرعية في صفقةٍ تنتصر للثورة المضادّة ومشروعها.
حسب أستاذ الأنثروبولوجيا، محمد حسن العامري، في تحليله شرعية النظم السياسية، يستند النظام على قيم أعضاء المجتمع، وتقوم الشرعية على أساس أن من يتّخذون القرارات يلتزمون بنظم المجتمع، ما يسمح بالالتزام بالقرارات والخضوع لها، وإنْ لم يلتزموا يستخدم القهر، وتهتم الأنثروبولوجيا السياسية بتحليل نمطين من المجتمعات. الأول يؤلف دولة والثاني نمط لا يؤلّف دولة. ويصعب في النموذج الثاني أن تتحدّد بسهولة أي شخص أو أو هيئة تتركز خلالها السلطة. وربما يُحدث هذا الخلل في النسق السياسي صراعاتٍ تتمظهر فيها أشكال القوة، بما فيها أشكال العنف والاحتراب الأهلي.
البشير وتوسيع مظلة التحالف الاجتماعي
استخدم عمر البشير الإدارات الأهلية لدعم حكمه، ولتمثل مرتكزات اجتماعية مستندةً إلى تاريخ طويل وقبول اجتماعي، ليضمن سيطرته بعد انقلاب 1989. عمليا قام البشير بتقوية نظام الإدارة الأهلية، وما تولّده من انقسامات على أرضية تمييزٍ متعدّدة الأوجه. ورغم ما قرّرته الحركة الإسلامية من أحاديث ودعوات ضد العصبية، إلا أن سياسة التعريب والأسلمة والتفريق على أساس الدم والقبيلة كان أقوى من رابطة الشعارات الإسلامية المرتكزة على الدين، والتي تحوّلت مع تحالف البشير مع الحركة الإسلامية إلى مجرّد شعارات للكسب السياسي، قبل أن تكون إطارا للفرز على المستوى الديني.
قام البشير بتقوية نظام الإدارة الأهلية، وما تولّده من انقسامات على أرضية تمييزٍ متعدّدة الأوجه
أصدر البشير قانونا ينظّم مهام الإدارة الأهلية، بعد أن ألغاه جعفر نميري (1970)، وحاول إبدال الاتحاد الاشتراكي، بينما حوّلها البشير عمليا إلى شبكة من حلفاء النظام، يدعمون الحكم من خلال السيطرة على الأقاليم، ولم يكن تأسيس “الجنجويد” (قوات أنشأها البشير في مواجهة الحركات المسلحة) سوى واحدةٍ من خطوات إشعال التطاحن القبلي، وتوسيع دوائر الحرب بين القبائل، كما جرى في دارفور وغيرها من المناطق. وزاد الأمر في تقسيم القبائل سياسيا أن كثيرين من ابناء القبائل الإفريقية. ولأسباب موضوعية، انضمّت إلى الحركات المسلحة ضد سلطة البشير.
مشروعات جهوية ضد مشروع المواطنة
تجدّدت الدعوة إلى الإدارات الأهلية بأن تدخل معترك السياسية بقوة بعد الثورة، وأن تمارس دورها الإيجابي فى السلم الاجتماعي. هكذا دعي البرهان وحميدتي، في إطار الحشد لانفرادهم بالحكم، إلى اجتماعاتٍ موسّعة مع زعماء القبائل، أداةً للاستقرار وحل النزاعات في الأقاليم. وهذا دور اجتماعي تقليدي مقبول، لكن الدعوة صاحبها تحريض زعماء القبائل للمطالبة بمشاركتهم في الحكم، ورفض انفراد المكوّن المدني، أحزاب الثورة وقواها الممثلة في “الحرية والتغيير”. وبذلك أصبحت هناك مواجهة بين نموذجين، مجتمع السياسة، والذي كان ممثلا في “قوى الحرية والتغيير” كتحالف معبّر عن الثورة، يتجاوز تقسيمات اللون والعرق والإثنية إلى حد بعيد، ونموذج مضادّ، مجتمع القبيلة والتمثيلات الجهوية. وذلك يمثل مواجهة بين مشروعين، نموذج للتحديث وآخر تقليدي، مشروع وطني ثوري جامع لكل السودانيين الذين يكافحون من أجل إنجاح ثورتهم، فى مقابل النزعات الجهوية والقبلية التى تتحصّن بها السلطة. وفى الإطار، شجعت السلطة بروز أصوات المكونات القبلية، عبر دعم تحرّكاتها، بل ودفعها إلى تكوين حركات وأحزابا سياسية، في مواجهة قوى الحرية والتغيير، والتى كانت ارتكبت أخطاء سهل معها استدعاء القبلية والجهوية بوصفهما إطارين منافسين ل”الحرية والتغيير” فى تمثل مطالب بعض المحتجّين من القوى الاجتماعية.
مواقف قوى الثورة
يمكن إيجاز مواقف قوى الثورة وأحزابها وقوها السياسية، في ثلاث نقاط: الأولى من حيث تحليل الحدث. اعتبرت أغلب قوى الثورة أن هناك أسبابا متشابكة، منها تقاعس أجهزة الأمن، والتوظيف السياسي للتنافس القبلي، إضافة إلى ميراث طويل من التهميش، غير تخلف أنظمة الإدارة الأهلية، واستخدمها كما جرى في عهود سابقة أداة لدعم السلطة، وتعزيز وجودها في الإقليم. ويمكن تلمس ذلك في بيانات لتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، غير مقالاتٍ لنخب سياسية، تناولت التوظيف والحشد القبلي في النيل الأزرق. هذا على مستوى التحليل، أما على المستوى الحركي ورد الفعل ميدانيا، فقد أرسل المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير وفدا قياديا وقافلة إغاثة إنسانية إلى النيل الأزرق، وبلورت القوى السياسية مواقفها بإصدار عدد من البيانات ومؤتمرات سياسية غير مظاهرة تدعون إلى مناهضة العنف والصراعات القبلية.
مخاطر العنف القبلى على مسار الثورة:
يبرز العنف القبلى، الحشد والصراع على أساس الهويات والانتماءات الأولية مع وجود أزمة لا تستطيع مؤسسات على المستوى القومي حلها. ولا يمكن تمثيل فئات المجتمع فى النسق السياسى، ما يجعل كل مجموعة تتخندق حول انتمائها الأولى، تتنظم وترفع رايات ومطالب وتنشى تنظميات أو تغذّي تنظمياتٍ قديمة، وهذا يتم فى مواجهة مشروع الثورة، والذي جاء لحل شامل، وتغيير من أجل الجموع التى ثارت، وعلى أرضية المواطنة والمساواة الكاملة ورفض التهميش. حينها تهدّد مشاريع الثورة التي رفعت مطالب عامة للجميع إلى حالة تفتّت يهدّد مستقبل الثورة والمجتمع ككل، وحين يتفسّخ النسيج الاجتماعي، وتعدّدت الصراعات على أسس غير طبقية، وتنحو نحو التمييز، يشكل ذلك وضعا، فى النهاية، يصبّ لصالح الثورة المضادّة التى تتلقف هذه الفوضى، وتبسط سيطرتها عبر الأجهزة الأمنية والنظامية، لتحتلّ موقع المنقذ الذى يتصدّى للفوضى، وتلقى حينها السلطة بما فيها المكوّن الأمني، قبولا واسعا أو ما يمكن تسميته حالة طلبٍ على الحل الأمني والعسكري، إذ لم يكن قائما. أما إذا كان حاكما، كما فى السودان، فإنه يرسخ وجوده ويبرّره، ويرسخ لحكم العسكر.
رؤية قوى الثورة لوقف العنف
ويقوم العنف نتاج وجود صراعاتٍ متعدّدة المستويات، ضمنها عملية التنافس على الموارد، وليس بالضرورة أن ينشأ في ظل الحرمان أو مظاهرة المساواة. ولكنه يحدُث حين يجد فرصا وعوامل ومحفّزات لإنتاجه. تشير كثير من قوى الثورة، أن الحدّ من العنف القبلي يستلزم الوصول إلى قواعد عادلة في مسألة التوزيع العادل للثروات والأرض، وأن يتم ذلك بين مكونات المجتمع عبر التقاء أطرافها للوصول إلى توافق، وهو ما يعني عمليا إبدال نموذج الإدارة الأهلية بنموذج آخر. ويشير الحزب الشيوعي، في بيان أصدره في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن “الحل الأمثل هو اللقاء الجامع الذي تشترك فيه القوى المدنية ممثلة في تنسيقي لجان المقاومة في الدمازين والروصيرص، ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية وممثلي القبائل المختلفة التي تقطن في المنطقة للحوار والوصول إلى حلولٍ مرضية حول التوزيع العادل للسلطة والأرض والثروة”.
كما تطرح القوى الثورية أو تجدّد مطالبها بأن لا يتم توظيف السلطة الصراعات القبلية، وأن يجمع السلاح وتدمج كل القوات المسلحة في الأجهزة النظامية، كما يجب أن يحدُث إصلاح حقيقي لمنظومة الأمن.
وعلى مستوى آخر، لا يمكن أن تكون الإجراءات الامنية أو المصالحات والمعالجات المتسرّعة، ذات فاعلية تحدّ من العنف في ظل وضع مرتبك وصراع على السلطة، واستمرار هيمنة تحالفٍ ضيّق عليها، وتهميش قوى اجتماعية وثورية، غير ازمتها من تفتت وانقسامات متكرّرة. وربما يتمثل الحل الجذري في إقامة نظام حكم يؤمن بقيم المواطنة، ويسير في تنفيذ إجراءات تحد من التمييز والتهميش، وتعمل على إحداث تنميةٍ يمكنها مستقبلا الحدّ من الصراع على الموارد في الجهات والأقاليم.